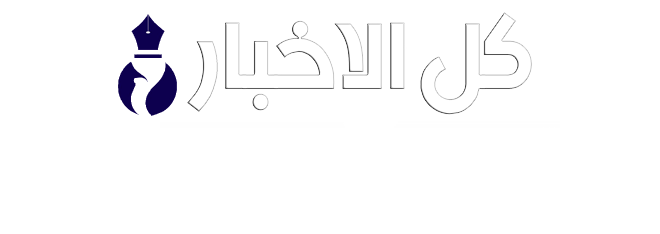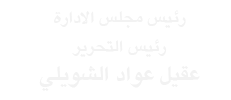الحكومة العالميّة للكاتب محمّد خليفة (الفكرة المهدوية: حقيقة قرآنية أم حاجة خلقتها الظروف)
2-ابريل-2022
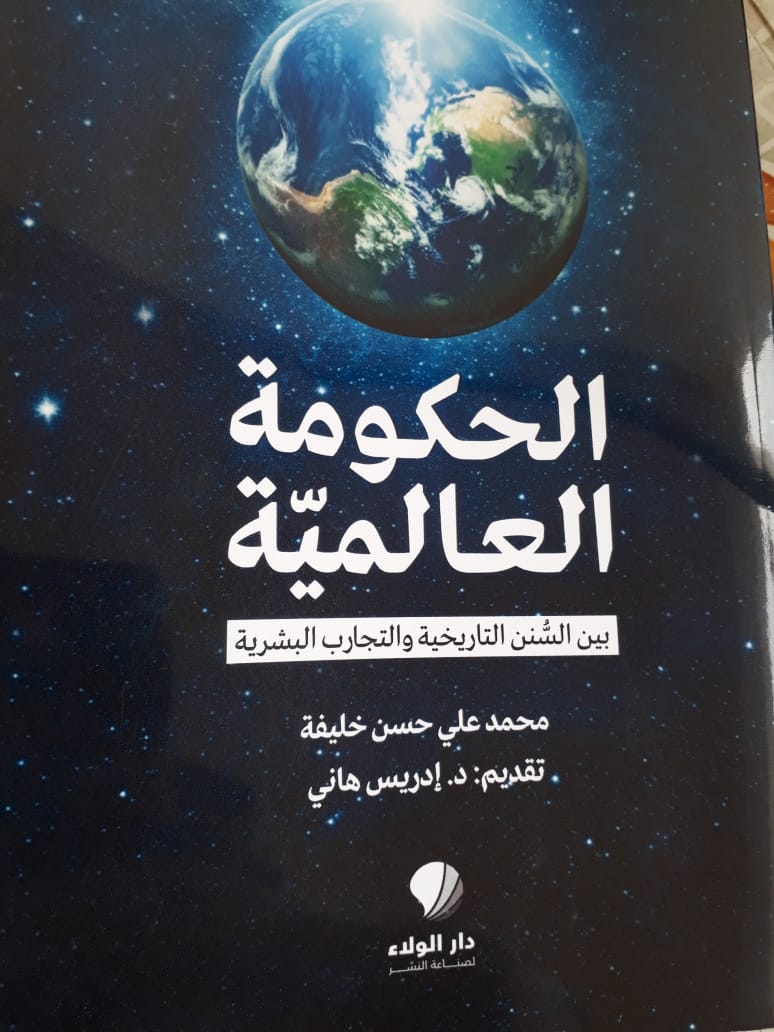 الدكتور علي نسر
الدكتور علي نسرفي كتابه الجديد، الحكومة العالميّة، يقدّم الباحث (محمّد خليفة) نصّا دراسيًّا، تقوم بنيته الرئيسة على ما يتّصف به التاريخ منذ نشأته، وهو الصراع، وهي بنية ذات ثنائية ضدّية طرفاها السنن التاريخيّة والتّجارب البشرية. ومن المعروف، أنّه في مثل هذا الصراع، ليست العلاقة نديّة تستوجب أن يثبت كل طرف وجوده أمام الطّرف الثاني، بل ينبغي أن يلغي طرفٌ طرفًا آخر، وهذا ما يؤكّده الكاتب حيث جلّ ما يسعى إلى إثباته هو حتميّة فشل التجارب البشرية الساعية منذ القدم إلى إقامة حكومات على مختلف الصعد، مؤكّدًا انتصار ما يخضع منطقيًّا إلى السنن التاريخية، تلك السنن الّتي أسهمت في تقويض تلك التجارب خاصّة حين تكون التجربة قائمة على ما يشبه التحدّي للسنن التاريخية التي يمكنها ذلك على مدى قصير، لكنّ هزيمتها تتوقّف على ما عاندته... وقد استطاع الكاتب، في النصف الأوّل من كتابه أن يقدّم نماذج من تلك التجارب، عبر منهج تاريخيّ موضوعي، تمكّن من خلاله إثبات وجهة نظره بالملموس والظاهر للعيان، معتمدًا القرآن مصدرًا رئيسًا ينهل منه ما يسهم في تغليف آرائه بالحجج والأدلة شبه النهائية، حسب خلفيته العقيدية، بالإضافة إلى بعض المراجع الإسلامية والعربية والأجنبية. وقد توصّل الكاتب إلى نتيجة كليّة، حاول الدفاع عنها، وهي أنّ الحكومة العالمية آتية في المستقبل، ولا مناص في ذلك، طارحًا سؤالًا في نهاية كتابه حول الشخصية الكاملة التي يمكن أن تتحلّى بالخصال الإلهية والنبوية والتي يمكن أن نتأمّل حدوثها في المستقبل لأنّها تدحض العديد من التجارب البشرية والدينية وتثبت فشلها، وهو يقصد المخلّص المهديّ، رغم أنّه أشار في البدايات إلى أنّ فكرة المخلّص موجودة لدى جميع الملل الدينينة سواء أكانت سماوية أم وضعية وهذا ما لم يكن من الأساطير ببعيد أيضًا، وبداية الكتاب تثبت ذلك.
كثيرة هي الحجج التي ساقها الكاتب ليؤكّد زيغ التجارب البشرية مقارنة بما هو سنّة إلهيّة، متّخذًا فكرة الكليّة الكونيّة، وهنا يقترب من النظرية الهيغيلية في تحليل الظواهر المادية والفكرية والأدبية، أكثر مما يقترب من الفكرة الإسلامية نفسها كما سنلاحظ لاحقًا. وهذه الكليّة تعمل على طمس دور الجزئيات، رغم أنّه انتبه في صفحات أخرى إلى دور الجزئيات وإن جعله خجولًا ويتيمًا. وهو قريب من الحقيقة فعلًا، لأنّ الجزئية وحدها قد تجني على نتائج الكليات، فالغصن اليابس في غابة خضراء ليس مقياسًا للحكم عليها. ولكن في الوقت نفسه، وما لم ينتبه إليه الكاتب، أنّ الكليّة تجني على بعض الأمور الجوهرية التي لا يمكن التغاضي عنها، فالغابة نفسها، وعبر رؤية كليّة لها، لا توفّر لنا فرصة الكشف عمّا في داخلها من وجع وأنين وأغصان ساقطة وحشرات خاضعة للإقصاء بسبب الحيوانات الكبيرة القوية وما شابه. كما لا يلتفت الكاتب إلى أنّ الكليّة القائمة بذاتها عبر جزئيات فسيفسائية تتضافر في ما بينها داخليًّا لاستقامة وجودها، هي بحدّ ذاتها جزء ضمن كليّات أخرى والقرآن نفسه ليس بعيدّا من طرح ذلك وكذلك الأحاديث العائدة إلى الرسول والصحابة والأئمة.
وعبر النظرة الكليّة، يفنّد الكاتب العديد من العوامل الّتي تجعل التجارب البشرية منذ ما قبل الميلاد وصولًا إلى اليوم، تتآكل تحت ضرباتها لمخالفة السنّة التاريخية الإلهية، وعلى رأس هذه العوامل، عدم الاهتمام بالإنسان وجوهره، تحت ذريعة النقيض الآخر الّذي أنتجته القوميات والتقسيمات الأنانية حسب تعبيره، وبعض الأديان والمذاهب. وهو محقّ في ذلك، لأنّ أيّ كيان لا يمكن أن أن يستقيم إلا عبر وجود عدّو حقيقي أو وهمي، وهنا ندخل في أنّ الضدّ يظهر حسنه الضدّ، وإن حاول الكاتب أن ينسف هذه الرؤية، علمًا أنّ القرآن نفسه حدّد سنّة الإقامة على الأرض والهبوط إليها عبر اتخاذ بعضنا بعضنا الآخر عدوًّا. وهنا نأتي إلى فكرة الصراع التي يدحضها الكاتب كمحرّك للتاريخ، علمًا أنه لولا الصراع لما استطاع أن يقدّم لنا هذا البحث القيّم، وذلك منذ العنوان (بين السنن التاريخية والتجارب البشرية). ولم ننفِ حقيقة ما قدّم، فالعدوّ موجود، والصراع أساس للهداية والضلال، حتى يكون هناك حجج دامغة يوم الحساب. أليس الشيطان ضرورة بالقوّة والفعل؟ وحين تولد الحكومة العالمية الّتي ستذيب المتناقضات على الأرض كما يعد بها الكاتب، فهل سيتنحّى الشيطان جانبًا وينتفي سبب الصراع بينه وبين الإنسان الّذي اتّخذه وسيلة ليتحّدى بها الله مع أنّ القرآن يؤكّد خطره حتى يوم القيامة؟ وهل فكرة الفئة الناجية وجعل كل معارض لها عدوًّا، خلت منها رؤية الدين عمومًا والمذهب خصوصًا؟ أليس كل مذهب قائمًا على اتهام الآخر بالكفر؟ أليس الظهور سيكون للثأر ممن يراهم المخلّص قتلة وكافرين؟ وهنا يفرض السؤال نفسه: هل سيكون في الحكومة العالمية المنتظرة، وجود للمخالفين؟ فالكاتب يؤكّد عدم وجود المخالفين تحت حجّة أنهم طغاة. وما مصير المخالف والباحث عن الحقيقة فكريًّا ممن لا يلتقون مع فكرة الحكومة القادمة؟ أليس هناك من رفعهم الله درجات كالمؤمنين وإن لم يكونوا مؤمنين بل ممن أوتوا العلم؟ ما مصير العباد ممن يستمعون القول فلا يتبعونه بل يتبعون أحسنه، أليس هذا دليلًا على سنّة التاريخ بوجود التباين بين البشر؟ أليس قول النبي (إلا بالتقوى) وقول الإمام علي: (أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) كافيين لتأكيد وجود حيّز للمخالف وسنّة الصراع الفكري؟ لم يجب الكاتب عن هذا السؤال رغم وروده لمحة سريعة، لكنّه ظل دون جواب. فهل يطبّق عليهم حكم السيّد قطب بأنهم جهلة والجاهل لا يحاور فكريًّا بل عبر سلوك حركي قد يؤدّي إلى العنف؟ أو ما يراه السيد الطبطبائي والشيخ المطهري حشرة مؤذية ينبغي دعسها، أو ماء مغرقًا يجب تجفيفه، أو نارًا محرقة يجب إطفاؤها أو حجرًا ينبغي إزاحته بحجّة أنهم مكابرون؟
إنّ الصّراع هو سنّة تاريخية أيضًا، وأوّل ما ظهرت ملامحه بين الملائكة والبشر، ثمّ بين الشيطان والبشر لاحقًا. فالكاتب يرى أنّ التركيبة البنيوية للكائن البشري جعلت الملائكة يتوجسون ويخافون من أنّه سيفسد ويسفك الدّماء، متناسيًا أنّ هذا لم يكن خوفًا بقدر ما كان حسدًا وهو باب من أبواب الصراع، لأنّ الملائكة سلّطوا الضوء على الجانب المظلم في الإنسان أو البشر، وكتموا الجانب المضيء، وحين أحرجهم الله بأنه يعلم ما يبدون وما يكتمون أقرّوا بالخطأ (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا). وهنا نستغل الفرصة، لنؤكّد للكاتب أنّ استخلاف الله للبشر في الأرض، كان استخلافًا للعباد عامّة، بما يحملونه من متناقضات اختصرها آدم نفسه، وترجمها إلهام النفس فجورها وتقواها، ومن سننه التاريخية أن تبقى هذه المتناقضات ولن تختفي إلا في الجنّة ليكون هناك حجة للحساب كما قلنا. وهنا نؤكّد، أنّ السنّة التاريخية أن تكون الأمانة ركن الوجود، الأمانة التي رفضت السماوات والأرض والجبال حملها، والتي يراها الكاتب الخلافة نفسها، علمًا أنّ الأمانة هي القدرة على الاختيار، وهذا ما يميّز الإنسان الذي تبرّع بحملها وإن كان هذا سيقوده إلى الكفر حسب الآية، وما سيجعله مميّزًا بجعله أكثر الأشياء جدلًا، مقرًّا أو نافيًا الكثير من الثوابت عند فرض المتغيرات نفسها، والله نفسه يؤكّد النسخ والتغيرات في آياته عبر (جملة شرطية) لطالما تغنّى الكاتب بها حجّة لإثبات فكرته، كما جعل الرهبنة مكتوبة رغم أنّها من اختراع أتباع المسيح لظروف أنتجتها فما كتبها إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا ما يؤكّد مقولة الوجودية، حيث الإنسان يحدّد هويته وماهيته من خلال خياراته ضمن المتناقضات المتصارعة، وهذا ما لم يتسنّ للملائكة والأنبياء عبر الوحي، إذ كانوا مسيّرين وعبيدًا، في حين أنّ الآدميين عباد في الأرض وليسوا عبيدًا وذلك بسبب اختياراتهم وعدم قبولهم بالتلقين الّذي كان سائدًا في الجنّة قبل الهبوط. وما جعل الملائكة يسجدون لآدم، هو القدرة على التعلّم واتخاذ القرار (علّم آدم الأسماء كلّها)، وليس فقط الاستخلاف في الأرض.
كما يمكن أن نسأل الكاتب، أليس مخالفة للسنّة التاريخية الإلهية، هذا الذوبان بين الأمم على مختلف الصعد، والله يؤكّد أنّ من آياته جعل البشر شعوبًا وقبائل للتعارف والكل ذوو إكرام والأكرم ذو التقوى (أفعل التفضيل لا تنسف الصفة عن الكلّ)، ولو شاء لجعلنا أمّة واحدة (لو شرطية للامتناع) والكاتب يؤكّد أهميّة الشرط في القرآن لإثبات وجهة نظره، بل كنّا أمّة واحدة ومن سننه هذا التباين ليكون له طعم خاصّ في الجنّة.
كما يمكن أن نسأل، هل الشخصية الكاملة التي ستسهم في خلق الحكومة العالمية وتقضي على التفرقة وتجعل الحياة لوحة واحدة مخالفة لما يتميّز به الكون من متناقضات، ستنجح أم أنّها عرضة للخرق والتحدّي بعد غياب مؤسسها كما حصل مع الأنبياء خاصّة أنّ الشيطان لن يغيب فهو من المنتظرين؟ فهل هناك كمال لبشري على الأرض؟ ألا تؤكّد رؤية الكاتب أنّ الخارج لبلورة هذه الحكومة سيقوم بما عجز عنه الأنبياء؟ هل سيكون هناك كامل ومتمم لما لم يقم به الأنبياء والقرآن واضح بأن النبي أكمل الدين وأتمّ نعمته؟ وهل سيكون حظّ الحاضرين في تلك الحكومة منجيهم في حين أنّ من لم يحالفهم الحظ سيكونون من الهالكين؟
ومن أبرز الحجج المنطقية اعتمادًا في الكتاب، كان اتخاذ المثال الأعلى، وهنا نسأل: هل المثال الأعلى حقيقة مطلقة. أليس كل ذي مثال يراه الحقيقة؟ والمثال الديني وغير الديني محطّة انطلاق تنميطية يخرج منها صاحبها ليروّض الوجود لصالحها ولو إسقاطًا وإقحامًا أحيانًا.
إنّ المنهجية البحثية الّتي تحلّى بها القسم الأوّل، تنحّت في الجزء الأخير من الكتاب، لصالح الطرح الأيديولوجي للكاتب، والأقرب إلى العاطفة والرسم الميتافيزيقي، وهذا طبيعيّ لأنّ الكاتب يتحدّث عن مستقبل بعيد أو قريب ولا يتحدّث عن ماض مضمون رغم أنّ الماضي نفسه لدى الأديان والشعوب ليس بمضمون، طالما تلاعبت به الروايات والسّيَرُ التي جاءت بعد قرون من غياب المتكلّم عليهم.
كلّنا نطمح إلى دولة كريمة في ظلّ عالم من الغابات. ولكن، هل من يؤكّد لنا فكرة المخلّص التي نحتاج إليها جميعًا، من خلال القرآن، الفكرة التي تستحق أن تكون ضمن المحكمات من الآيات وليس المتشابهات الّتي يصبح فيها التأويل خطرًا فيه من الفتنة والزيغ الكثير.