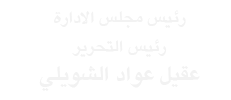بين المسيحيّة والإسلام... ليس مجرّد أعياد
22-ديسمبر-2021
 علي نسر
علي نسرممّا لفت النّظر، قبل بضع سنوات، التزامن بين ولادتي صاحبي أكبر رسالتين سماويتين في العالم، ضمن شهر واحد، إذ يحصل هذا الالتقاء كل ثلاثة عقود تقريبًا، نظرًا إلى تقلّب الشهر القمري، واستغلّ الناس هذه الصدفة محاولين الإطلالة على ضرورة التعايش المشترك متبادلين التهاني والتبريكات. لكنّ اللافت في ذلك الحدث، وربما في السنوات القادمة، ما تفرضه الأحوال الملتهبة في وطننا العربي، من حاجة إلى التلاقي بين الأديان عمومًا والمذاهب داخل الدين الواحد خصوصًا... فما نشهده من عناق الأهلّة والصّلبان، بالإضافة إلى تكاتف الكنائس والمساجد، مرورًا بتردّد صدى الأذان عبر أثير رنين الأجراس، ليس بالمستهجن، لو ترك ورثة الديانتين الحالَ كما ينبغي أن تكون عليه، لأنّ من يغُصْ في تلافيف الأديان عمومًا، يجدِ التقاطعاتِ تفوق التبايناتِ، بل إن الأديان يتناسل بعضها من بعضها الآخر مع تغيّر اسم النبي أو الرسول فقط.
ستّة قرون تفصل بين المسيح(ع) ومحمّد(ص)، ومع ذلك فإنّ التعاليم الصادرة عن المصدر نفسه، لم تتغيّر إلا من خلال الصوغ، ومراعاة المستوى الفكريّ لدى متلقّي الوحي والرسالة. لذا، لا نستطيع أن نجعل العلاقة بين الديانات المتعاقبة علاقة جدلية، وإن حاول الكثيرون من القيّمين والمروّجين لها خطأ، سهوًا أو عمدًا، أن يجعلوا العلاقة بين الرسالات علاقة ذات طبيعة ثنائية ضدية، ما يقتضي أن تسود القطيعة بينها، اعتمادًا على مبدأ الجدلية الذي يقول بإلغاء أحد الطرفين الطرفَ الآخر في أيّة ثنائيّة على هذا الشكل، وهذا ما اقترفه كبار العلماء من الطرفين. فليس الإسلام خروجًا على المسيحيّة، إنّما هو تكريس لها، خرج من رحمها وعمل على صونها وتثبيتها فعلًا دينيًّا يشكّل امتدادًا لما سبقه من أفكار دينية سماوية وغير سماوية. فالرحمة التي رفعها الاسلام شعارًا، ليست سوى إتمام لشعار المحبّة الذي رفعه المسيح. لم يلغِ الإسلام المسيحية كما تلغي الثمرة الزهرة التي انبثقت منها، وما شهده التاريخ من مشاهد إلغائية عبر حروب دموية بينهما، كان من فعل أيديولوجيا كلتا العقيديتين، إذ حصل الخلاف في التطبيق، حين استحالت الديانتان، كيوتوبيا، مباحتين للحاكم والسلطة فتمّ توظيفهما سياسيًّا، والدليل أن التمزّق والتباعد بينهما، دمويًّا وإقصاء، شهدهما الدين الواحد عبر صراعات مذهبية ضيّقة، ومشهد اليوم خير مثال. إنّ هاتين الديانتين تلتقيان في العديد من القواسم المشتركة دائمًا. تلتقيان في الفعل الإلهي، من دون إهمال الجانب الآدمي حتى في إتمام المعجزات، حيث الدين وسيلة غايتها الإنسان... فما بين الديانتين أكبر من مجرّد التقاء الميلادين وتجلّيهما عبر القرون... فللإسلام فضل على المسيحية لا يمكن تجاهله، إذ لا يعدّ مسلمًا من يطيح بالديانة السابقة ولا يعترف برسولها... لكن فضل اللاحق على السابق، قد يكون عاديًّا ومألوفًا، بيد أنّ الفضل الذي ينبغي الالتفات إليه هو فضل السلف على الحديث... وفي هذا، لا يمكننا إلا أن نحصر ما قدّمه الإسلام سابقًا الى توأمه المسيحية، وما يحاول المسلمون بقطبيهم المعتدلَينِ (طبعّا) اليوم، أن يقدّموه خدماتٍ لحماية المسيحيين المهدّد وجودُهم، على أيدي التطرف القادم والمجتثّ كلّ من وما لا يشاطره الفكر الإلغائي التكفيري، ليس سوى ردّ جميل وسداد ديون للمسيحيين لما أسهموا فيه من دور في إنجاح الدعوة المحمدية وتثبيت أقدامها في رمال الصحراء الغارقة في عبادة الأوثان آنذاك. وسواء كانت أعمال الاعتدال الإسلامي، مقصودة أم عفوية، إلا أنّه يمكننا الاستنتاج بأنّ في اللاوعي الجمعي الإسلامي تترسّب فكرة الديون والجميل والفضل التي يمكن لهذه الأعمال وما فيها من حماية المسيحيين، بشرًا وحجرًا وشجرًا، أن تسدّدها وتعيدها إلى أصحابها، إذ لا يمكن لمسلم معتدل، أو عربيّ أصيل، إلا الاعتراف بالأدوار التي أدّاها مسيحيو الشرق في خدمة إنجاح الدعوة الإسلامية أوّلًا، والإسهام في تبلور الوعي القومي ثانيًا... وكثيرة هي المحطات التاريخيّة التي تشهد للدور المسيحي في مساعدة الإسلام قبل الرسالة وخلال نزول الوحي وبعد ذلك... إذ من خلال وجود الديانة المسيحية وانتشار رهبانها وقساوستها في بلاد العرب إبّان العصر الجاهلي، بقي الفكر مروّضًا على تقبّل فكرة التوحيد، وحافظت الأذهان على فكرة الاتصال بين السّماء والأرض عبر الوحي والملائكة، وكثيرة هي الآيات القرآنية والأبيات الشعرية الجاهلية التي تشير الى ذلك. وبهذا يكون المسيحيون قد شكّلوا جسرَ تواصلٍ بين ديانة ابراهيم الحنيفة المفقودة، والتي كان الغيورون على المجتمع، ومنهم الرسول نفسه قبل الوحي، يبحثون عنها كطريق خلاص، وبين التبشير بالدعوة المحمدية، رغم هيمنة الوثنية على عقول الناس وانغماس العرب فيها... وكذلك يعود لهم الفضل في حماية القلّة من المبشّرين بالدين الجديد، حين حصلت الهجرة الإسلامية الأولى قبل الذهاب الى يثرب، وذلك عبر إرسالهم من النبي إلى ملك الحبشة النصراني الذي لا يُعرف أنّ أحدًا قد ظُلم عنده... فبرغم بعد المسافة جغرافيًّا، إلا أنّ الرسول آثر أن يقصده حمايةً لطليعة التبشير رغم اقتراب القبائل العربية جغرافيًّا وقرابة في الصحراء والعراق والشام...لكنه كان يخشى من سطوة قريش عليهم كقبائل ذائبة في سيادتها، وكدولٍ يسيطر عليها الأعداء من فرس وروم، على التخوم المحيطة أيضًا...هذا بالإضافة إلى فضل القسّ (ورقة بن نوفل) في تثبيت إرادة الرّسول، مُقرًّا بملامح الوحي والنبوّة، حين رأت زوج النبي ضرورة استشارته، في الوقت الذي كان النبي (المدثر) نفسه ينتابه الشك حاسبًا أنّ شيطانًا قد مسّه وجنونًا قد أصابه...ما جعل النصارى أقرب مودّة للّذين آمنوا.. هذا بالإضافة إلى دور روّاد النهضة القومية، الذين نادوا باستقلال الأقطار العربية، بمسلميها ومسيحييها، عن السلطنة العثمانية، ما أسهم في وضع الحجر الأساس لفكرة القومية الحديثة التي بزغ نجمها في القرن العشرين، وكان من هؤلاء مسيحيون كثر...